أخبار عاجلة

ما وراء العلمانية الظاهرة: تأصيل الحداثة السيادية في المجتمعات الإسلامية (العراق أنموذجاً)
ما وراء العلمانية الظاهرة: تأصيل الحداثة السيادية في المجتمعات الإسلامية (العراق أنموذجاً)
بقلم/ عدنان صگر الخليفه
لقد ظلّت المجتمعات الإسلامية، وفي مقدمتها العراق، تعاني من استقطاب فكري مزمن يدور حول العلاقة الجدلية بين الإيمان ومقتضيات التحديث. يكمن الخطر الأصيل في الانزلاق نحو تبني تحليلات غربية تعمل على اختزال جوهر رسالة الدين إلى مجرد "ظاهرة سوسيولوجية" قابلة للتفكيك، متغافلين عن حقيقة الدين بوصفه "منظومة حياتية متكاملة" ذات منشأ إلهي مُنزَّل. هذا الاعتراض ليس حُكْماً لاهوتياً، بل هو استدلال منطقي وعقلي؛ إذ كيف يتسنى للعقل البشري، بصفته مخلوقاً محدوداً، الإحاطة بماهية الخالق المطلق أو تجزئة مصدر تشريعه؟ إن الوظيفة القصوى للعقل تنحصر في إثراء طرائق التطبيق السديد لهذه المنظومة التشريعية وتجديد فهمها، لا في تفكيك مصدرها الثابت.
إن هذا المسلك الغربي، الذي يقوم على نقد الأديان وتجزئتها، ينبع تاريخياً من خلفية صراعية نشأت في السياق الأوروبي لتجاوز احترابها الديني، ولا يستهدف بالضرورة خدمة مصالح مجتمعاتنا. ومما يؤكد ازدواجية المعايير لديه هو تجنبه الملحوظ للنقد الحاد للديانات ذات الثقل السياسي العالمي، في مقابل سعيه لتأسيس صورة نمطية لـ "التطرف المتكافئ" بين الأديان لتبرير علوّ نموذج العلمانية الغربي ومن ثم تكريس الوصاية الفكرية علينا. هذا الضغط يستولد ما يمكن وصفه بـ "الكيان المسلم الهجين" أو "المشوه"، الذي يقدم تضحيات في أصوله وقيمه كـ "ثمن إلزامي" للانخراط في سلك الحداثة، فيغدو فاقداً للمرجعية الواضحة؛ إذ لا يستقيم على مبادئ الليبرالية الأصيلة ولا على أصوله الإسلامية، مما يجعله فريسة سهلة إما للتطرف العقائدي أو للّيبرالية المُحَوَّرة القابلة للتسيير والتحكم.
يُشكل الواقع السياسي العراقي في أعقاب عام 2003 شاهداً بليغاً على حتمية رفض هذه الوصاية، حيث أفضى التداخل المربك بين القرار السياسي والمرجعية الدينية إلى تآكل بناء الدولة وإضعاف سيادتها. فحينما يعلن القادة السياسيون خضوعهم لـ "أمر المرجعية"، في الوقت الذي تصرح فيه المرجعية بـ "عدم التدخل المباشر في الشأن التنفيذي"، يغيب بذلك القرار السياسي السيادي الفعلي، ويُرمى عبء المسؤولية على كاهل الأمة في حلقة من الإفلات والتبعية. هذا الامتزاج ينطوي على خطورة بالغة؛ فالصناعة السياسية تتطلب مرونة فائقة و "حيّزاً تقديرياً" ضرورياً للتعايش مع التعددية المجتمعية، بينما الأحكام الدينية، في جوهرها، تتسم بالإطلاق والثبات، ولا تقبل التنازل الجذري. إن محاولة إدارة شؤون الدولة الحديثة بأحكام ذات ثبات مطلق تؤدي بلا شك إلى الفشل في تدبير الشأن العام وتغذية النزعات المتطرفة. وتتفاقم الأزمة لأن هذا النظام القائم على المحاصصة يحظى برعاية دولية وإقليمية تضمن استدامته وبقاءه، الأمر الذي يجعل إصلاحه الجذري من الداخل مهمة شبه مستحيلة.
إن تجاوز هذه الحلقة المُغلقة يستلزم استعادة "حق الإدارة الذاتية" والمُضي في تأسيس "حداثة سيادية" مستلهمة من مرجعيتنا الذاتية. إننا لا ندعو إلى القطيعة الحضارية، بل إلى "الاستفادة الانتقائية" المدروسة؛ نستقي العلوم والمعارف الحديثة وننأى عن الوصاية والأيديولوجيات المخالفة لمعتقداتنا. يجب ترسيخ فصل وظيفي صارم بين سلطة إصدار القرار السياسي (صاحب السيادة الدستورية والمؤسساتية) وسلطة إصدار القرار الديني (صاحب المرجعية العقائدية). تقع على عاتق السياسي مهمة سنّ تشريعات وطنية تضمن الحرية، والديمقراطية، والتعايش للجميع، وهي تشريعات يجب أن تنبع من المرجعية التي قررت حرية الإنسان، وليست مجرد أنماط سلوكية مستوردة لا تلائم مجتمعاتنا. فالسبيل الأوحد لضمان سيادة الدولة واستقرار المجتمع العراقي هو بالتركيز على صناعة القرار الوطني المستقل، الذي يُعلي من شأن الأصول الإيمانية كـ "قيمة مؤسِّسة"، ويستخدم مرونة السياسة كـ "آلية للإنقاذ وتحقيق التنمية المستدامة".

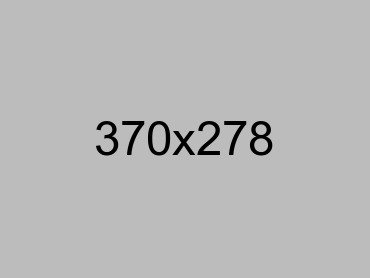










التعليقات الأخيرة